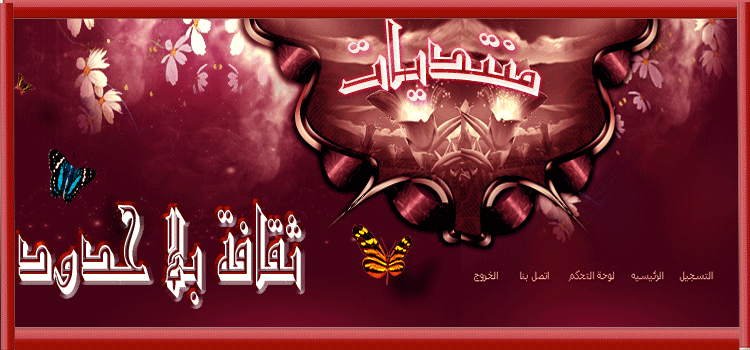الحديث عن القادة شيء ممتع ويبعث على الرغبة في
مواصلة القراءة والإستمتاع
حتى آخر كلمة, لكن الحديث عن محمد – صلى الله عليه وسلم – فهو شيء آخر,
ويبعث على الفرح والسرور النفسي, ويزيدك طمأنينة وراحة بال.ما أحب أن أتحدث به في مقالي المتواضع أمام حبيبي محمد – صلى الله عليه
وسلم – هو الشيء اليسير أمام عبقريته الفذة في القيادة, ولماذا لا نقتدي به
فعلاً ؟ إن كنا نعتقد بأنه القدوة الفعلية والعملية لنا في مسيرة حياتنا,
لماذا ندّعي الحب الخالص والمجرد لرسولنا الكريم بينما لا تلامس سيرته
حياتنا, وهي بعيدة كثيراً عن الروح التي علمنا إياها في سيرته العطرة.
ما أود التركيز عليه هو أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - النموذج
التطبيقي لنا في حياتنا القصيرة التي نعيشها, وهو القدوة لنا في نجاحنا
الحقيقي في هذه الحياة, فإذا ما أردنا التطوّر فهو من سيعرفنا الطريق, وإذا
ما أردنا أن نعيش كما يحب الله, فعلينا أن نسير على خطاه, وأن نحبه كما
علمنا عندما قال للفاروق عمر : " ومن نفسك يا عمر, فقال الفاروق : ومن نفسي
يا رسول الله ".
علمني حبيبي محمد – صلى الله عليه وسلم – أن أكون واقعياً :فمعرفة الواقع الذي تعيشه هو بداية الطريق للنجاح, عندما قرر محمد – صلى
الله عليه وسلم – أن لا فائدة من الدعوة في مكة, اتخذ قرار الهجرة, لأنه
يعلم يقيناً أن الدولة لن تقوم من دون أن يأمن أصحابه من غدر أعدائهم,
فيستريحوا قليلاً من الأذى لينظروا لبناء الدولة التي سيشع نورها على
العالمين, كان رسول البشرية يدرك ذلك جيداً, وإنما اتخذ الأسباب الدنيوية
في الدعوة في بيئة يغلب على طابعها الإحتكام للسلاح كحل وحيد لحل مشاكلهم,
فلم يكن من المجدي أن يقوم بمزيد من المحاولة, بعد أن عرض نفسه على الوفود
الكثيرة التي كانت تحج لبيت الله الحرام, طمعاً في النصرة, وبعدما سافر
للطائف لنفس الغرض فلقي من الأذى النفسي والمادي ما لا يحتمله إلا الرجال
العظماء, وذاك هو محمد – صلى الله عليه وسلم-.
ما نتعلمه من ذلك ليكون لنا درساً عملياً هو أن نعرف أين نقف الآن؟ وإلى
أيّ وجهة نسير؟ وما هي رؤيتنا للحياة التي ننشدها؟ عندما ندرس مواقفنا ندرك
مدى الفجوة العميقة بين ما نريد أن نحقق, وأين نقف الآن مما نريد, فليس
النجاح بالتمني ولكن هو المحاولة والمحاولة والمحاولة حتى نحسن من أداء ما
نقوم به, فأن تخطأ وتقع على الأرض, لا يعد خطأً في حدّ ذاته, لأنك بذلك
ستكون قد تعلمت أن هناك طرقاً لا تصلح لنسلكها, وإنما الطامة الكبرى أن لا
نتقبل الخطأ ونتخذه شماعة للتوقف عن التقدم, والتوقف عن معرفة ما الذي
نريده.
علمني حبيبي محمد – صلى الله عليه وسلم – أن قيمة المشروع أكبر من قيمة العواطف :إذ أن الفكرة أكبر من العواطف, كان رسول الإنسانية يدرك أن قرار الإبتعاد
عن مكة, فيه من الظلم الكثير لمشاعره ومشاعر أصحابه, لكنه مؤمن بفكرته
وعازم على أن يدافع عنها أو يهلك دونها, فلم يكن للعواطف متسع أمام مفارقة
الديار والأهل, فهو القائد ذو البصيرة النافذة, عليه أن يبحث عن موطيء قدم
له ولأصحابه, ليتمكن من بناء الدولة, حتى لو على حساب مشاعره.
علمنا محمد – صلى الله عليه وسلم – أن ندافع عن أفكارنا, وعن ما نعتقد, فما
قيمة الإنسان إذا عاش في عباءة الآخرين, يتكلم كما يتكلمون, وينفعل كما
ينفعلون, هكذا, وبدون أدنى قوة داخلية تدفعه للتوقف ليكون غيره, إلا أن
يكون إمّعة مع نفسه ومجتمعه, فما قيمة المرء إن كان لا يحسن قيمة العيش مع
نفسه ومجتمعه, وما الذي تطمح لتغييره في إنسان مغيّب عن واقعه, لا يملك
أحلاماً يدافع عنها, ولا فكرة يضحي من أجلها, وما أعنيه أننا جميعاً لدينا
مشاريع فليس من العدل أن نقتلها في مهدها, ونجلس بلا فكرة تراودنا أو أحلام
نعشقها.
علمني حبيبي محمد – الله عليه وسلم – أن للقائد خيارات متعددة :فليس من العدل إذا أوصدت الأبواب أمامك أن لا تفكر في خيارات أخرى, وهذا ما
فعله رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عندما قرر الذهاب للطائف لعله أن
يجد النصرة منهم, وهذه حكمة منه, وعندما أوصدت الأبواب لتبليغ دعوته, كان
عليه التفكير ملياً في خيارات أخرى, لينقذ بها دعوته وأصحابه الكرام, فذهب
للطائف لكنه صلى الله عليه وسلم لم يجد آذاناً صاغية ولا قلوباً تتلمس
الحق, فعاد مرة أخرى لمكة مستجيراً بمشرك, وعندما أرسل سيدنا مصعب بن
العمير مع ستة من الأنصار للمدينة, كان هدفه استشراف الأرض الجديدة ومدى
ملائمتها لتكون منطلقاً للدعوة وبناء الدولة.
وهكذا هي الحياة, إذا لم تكن مرناً في تفاصيلها, فلن تجد باباً يفتح أمامك,
فهناك من يحدد مسبقاً أن طريقته في فهم الإسلام هي الطريقة المثلى ليقتدي
بها الناس, فيأخذهم بالإكراه مرة وبالتعنيف مرات, من دون أن يعلم أن رسولنا
الكريم, لم يكن ليوصد باباً للتعريف بالحق, ولم تكن خياراته تنفذ في سبيل
إيصال هذا الحق للناس, حتى مع من خالفوه في الدين فما بالك بمن خالفوه في
الرأي, لا توصد أبواب الخير, فأحب الخلق إلى الله أنفعهم لخلقه