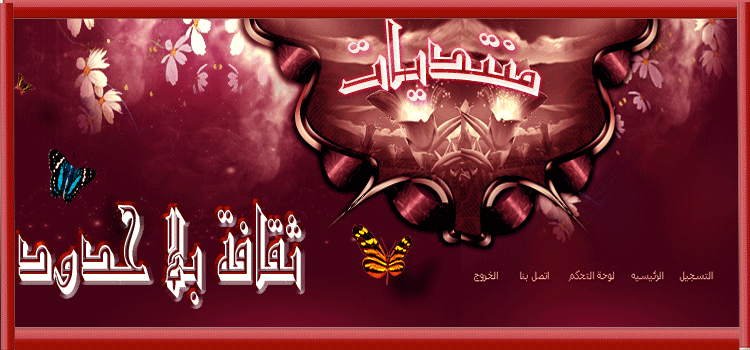فقهاء التنوير الحلقة 4 الإمام جعفر الصادق.. معلم الأئمة..اشتهر عنه حب صحابة رسول الله أجمعين وكان يقول «من لا يعرف فضل أبى بكر وعمر فقد جهل السنة» 
هاجم فقهاء السلاطين وكان يقول للناس «إذا
رأيتم العالم يحب الأغنياء فهو صاحب دنيا.. وإذا رأيتموه يلزم السلطان من
غير ضرورة فهو لص».
حارب الأغنياء مفتيا بأنه لا يجوز ادخار
أكثر من قوت عام إذا كان فى الأمة صاحب حاجة كما حارب انتشار الدعوة إلى
الزهد لأنها تزيد الفقراء فقرا والأغنياء غنى.
بالغ البعض فى تقديره فرفعوه إلى مراتب النبوة، وبالغ البعض الآخر فى
التهوين من شأنه فلم يذكروا عن فضله إلا كلمات قليلات أتبعوها بذكر تطرف
بعض المنتسبين زورا إليه وشططه وكأنهم يعايرونه بتطرف المتمسحين به، لكنه
وبلا مبالغة فى التقدير أو التهوين معلم الأئمة ومخضع الجبابرة ونصير العقل
الأول، وحامل شعلة الفقه النبوى، وموحد المسلمين على الكلمة السواء.
هو الإمام جعفر الصادق بن الإمام محمد الباقر بن الإمام على زين العابدين
ابن الإمام الحسين بن الإمام على بن أبى طالب عليهم جميعا رضوان الله، الذى
أجمع على محبته وتقديره الراسخون فى العلم سواء كان من أصحاب المذهب السنى
أو المذهب الشيعى، ولا تكاد ترى إماما عالما إلا ويجل «الصادق» ويعطيه حقه
من التبجيل والتوقير، ذلك لأنه كان عابرا للانحيازات الضيقة ومتساميا فوق
صغائر الدنيا، ومترفعا عن طلب المال والسلطة والجاه، فتعب خصومه وانهزم
أعداؤه ونكل بكارهيه دون أن تتلوث يده الشريفة بما يسوؤها.
ورث إمامنا الإمام الصادق عن أبيه الإمام محمد الباقر وعمه الإمام زيد بن
على زين العابدين وأجداده العظام الكرام حب الناس وحب التقريب بينهم ونبذ
الفرقة وكان يتوارث حكمة أبيه القائلة: «إياكم والخصومة فى الدين فإنها
تحدث الشك وتورث النفاق» فكان لا يخاصم أحدا أبدا، متمثلا قول رب العزة:
«ادْفَعْ بِالَّتِى هِىَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِى بَيْنَـــكَ وَبَيْنَهُ
عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِىٌّ حَمِيمٌ» فكان لا يعبس فى وجه سائل، ولا يضيق
بجدل قط، وكأن العالم كله من عياله.
اشتهر عنه حب صحابة رسول الله أجمعين، وكان مثله مثل أجداده العظام الكرام
يبجلون أبا بكر وعمر وعثمان، وحفظ كلام أبيه «محمد الباقر» عن ظهر قلب، وقد
كان يقول رضوان الله عليه: من لا يعرف فضل أبى بكر وعمر فقد جهل السنة»
ويروى عنه أنه قال لصاحبه جابر الجعفى: «يا جابر، بلغنى أن قوما من العراق
يزعمون أنهم يحبوننا ويتناولون أبى بكر وعمر رضى الله عنهما، ويزعمون أنى
أمرتهم بذلك، فأبلغهم أنى إلى الله برىء منهم، والذى نفس محمد بيده لو وليت
لتقربت إلى الله بدمائهم، لا نالتنى شفاعة محمد إن لم أكن أستغفر لهما
وأترحم عليها، إن أعداء الله عنهما لغافلون».
أيقن إمامنا من أن للحق وجها واحدا، وللباطل أوجها لا حصر لها، فخشى من أن
يضيع وجه الحق متشتتا فى محاربة أوجه الباطل، ولزم داره لا يطلب حكماً ولا
يسعى لإمارة، واهبا نفسه للعلم والفقه والإبحار فى ملكوت الله متأملا مسبحا
مستكشفا، أريقت دماء أهل البيت الطاهرة أمام عينيه، فما زادت إلا إصرارا
على كشف الزيف، ورأى أن طلب العلم هو الجهاد الأكبر، فصار مرشدا روحيا
للأمة تهابه الملوك، وتهواه القلوب، صانعا من لسانه سيفا يحارب به من يبدل
دين الله ويتاجر به ويستخدمه لأغراضه التسلطية الجشعة البشعة.
ولأنه صار منزها عن الغرض، ظل الإمام يحارب فقهاء السوء وعلماء السلطة
متخذا من عمه الإمام زيد وأبيه الإمام محمد الباقر قدوة ومثلا، وكان يقول
للناس: «إذا رأيتم الفقهاء يركبون للسلاطين فاتهموهم» وكان يردد قول أبيه:
«إذا رأيتم القارئ (أى العالم) يحب الأغنياء فهو صاحب دنيا، وإذا رأيتموه
يلزم السلطان من غير ضرورة فهو لص» ولهذا صار يفتى بما لا يحب السلطان ولا
يهوى، ناشرا فتاوى الإمام على وراويا الأحاديث النبوية التى سمعها آباؤه
منه وأخفاها السلاطين طمعا فى الدنيا والسلطة وإرباكا للناس وإبعادا لهم عن
حقوقهم المشروعة، فأفتى بأنه لا يحق للمسلم أن يدخر أكثر من قوت عام إذا
كان فى الأمة صاحب حاجة إلى طعام أو مسكن أو كساء أو دواء، أو ركوبة، كما
أفتى بأن السارق إذا اضطر إلى السرقة لأنه لا يعمل فولى الأمر هو المسؤول
وهو الآثم فإذا سرق السارق اضطرارا لأنه لا يحصل على الأجر الذى يكفيه هو
وعياله فإن ولى الأمر وولى العمل أولى بقطع اليد من السارق!!
وبالطبع لم تعجب هذه الفتاوى سلاطين بنى أمية ولا بنى العباس، فتربصوا به
وأرادوا أن يفرقوا الناس من حوله لكنهم لم يستطيعوا، ليقين الناس بنبل غرض
الإمام وصدقه وتمثيله الصادق لروح الشريعة الإسلامية وسماحتها، وقد رأى
الإمام أن السلاطين يشجعون الناس على الزهد فى الدنيا والكف عن طلب محاسنها
وطيباتها، وأيقن من أن تلك الدعوة الخبيثة تحمل فى ظاهرها صلاح النفس
لكنها تحمل فى باطنها الفساد فى الأرض، فلكل دولة موارد وخيرات، وإن لم
ينتفع بها فقراؤها زاد بها غنى أغنيائها، كما رأى الإمام أن هذه الدعوة
تصرف الناس عن المطالبة بحقوقهم كما تصرفهم عن محاسبة أولى الأمر، فحارب
الإمام هذا التوجه، وأخذ يتلو على الناس من أحاديث الرسول ما توارث حفظه من
آبائه وأجداده، وقال لهم أن إغناء الأبناء وإعانة النفس خير عند الله من
اصطناع الزهد وترك الأبناء فى الحاجة، ذاكرا قول رسول الله صلى الله عليه
وسلم «خمس تمرات أو خمسة دنانير أو دراهم يملكها وهو يريد أن ينفقها
فأفضلها ما أنفقه على والديه، ثم على نفسه وعياله، ثم على قرابته من
الفقراء، ثم على جيرانه الفقراء، ثم فى سبيل الله، وحكى لهم إن رسول الله
قال فى واحد من الأنصار أعتق ستة من الرقيق عند موته وكان لا يملك غيرهم
وله أولاد صغار ظنا منه أنه يتقرب إليه الله بعتقهم: لو أعلمتمونى أمره ما
تركتكم تدفنونه مع المسلمين».
ولأن الدعوة إلى الزهد اجتذبت العديد من الصالحين انتهز الإمام فرصة لقائه
بأحد الصالحين الداعين إلى الزهد وهو أبوسفيان الثورى فحاوره حول دعوته
وأظهر له أن التمتع بالطيبات لا يتنافى مع الإيمان تصديقا لقول رب العزة
«أحل لكم الطيبات» وكان «الثورى» قد قابله يوما وهو فى ثياب حسنة فأنكر
عليه ذلك قائلا: هذا ليس من لباسك، فالتفت إليه الإمام الصادق متخذا لهجة
المعلم قائلا: اسمع منى ما أقول لك فإنه خير لك آجلا أو عاجلا، إن أنت مت
على السنة والحق ولم تمت على البدعة. أخبرك بأن رسول الله صلى الله عليه
وسلم كان فى زمن مجدب مقفر فأما وقد أقبلت الدنيا فأحق بها أبرارها لا
فجارها، ومؤمنوها لا منافقوها.
أعتقد أنه بعد إيرادنا لهذه الأمثلة لا يحتاج الواحد إلى التأكيد على أن
الإمام الصادق كان متحررا من التقليد فاتحا باب الاجتهاد على مصراعيه مؤمنا
بقدرة العقل على دحض دعاوى الملتصقين بقشرة الدين، وكان رضوان الله عليه
يعتمد على منهاج العقل بشقيه اعتمادا كبيرا، فكان يعمل عقله «مجردا» فيما
لم يرد فيه تنزيل بتعريف ما هو حسن وما هو قبيح مفترضا أن الله خلق الإنسان
عارفا الحسن والقبيح فما هو قبيح تجنبه وما هو حسن اتبعه معتبرا إياه جزءا
من الشرع، كما كان يعمل عقله بالتخريج على ما جاء فى الكتاب والسنة مدخلا
فى ذلك بعض الأقيسة التى تثبت علتها واستقامت طريقتها.
ولأن الإمام يعرف أن الله أودع أسراره فى كتاب الله كما أودعها فى ملكوت
الله، كان كثيرا ما يبحر فى علوم الدنيا متقلبا بين دراسة الفلسفة التى
يظهر آثارها فى محاججته للمتشككين فى العقيدة والكيمياء والحساب، وليس أدل
على براعته فى تلك العلوم الدقيقة من تتلمذ جابر بن حيان مؤسس علم الجبر
وأبوالكيمياء على يديه، وكان أبوجابر من أنصار آل البيت الذين استشهدوا
دفاعا عنهم فتعهده الإمام محمد الباقر بالرعاية التى ورثها عنه الإمام
الصادق الذى أخذ بيده وأنفق عليه وحثه على دراسة علوم الدنيا وزوده بمعمل
وأمره بكتابة أبحاثه لينتفع بها الناس، وكان يستعين بمعارفه العلمية على
فهم الأمور الفقهية، كما كان يستعين بخبرته الكبيرة فى العلم على الإبحار
فى علوم الفقه.
ولأن الإمام عاش فى عصر يموج بالتيارات الفكرية والفلسفية كان واجبا عليه
تحملا منه لمسؤوليته التاريخية أن يدلى بدلوه فى تفنيد آراء المشككين
والمتشككين فى العقيدة والخلق والألوهية، وحفظت لنا كتب السيرة والتاريخ
التى سجلت سيرة الإمام ومحاوراته مع هؤلاء المتشككين ما يؤكد أنه رضوان
الله عليه كان يؤمن بحرية الرأى والعقيدة، فها هو يذهب إلى العراق لأنه سمع
أن بها بعض الملحدين الذين يشككون فى الدين ليناقشهم ويجادلهم بالتى هى
أحسن، لم يهدر دمهم ولم يأمر بقطع رؤوسهم ولم يرمهم بالكفر وهو جالس فى
بيته، بل ذهب إليهم بنفسه متعرفا إليهم ومقدما نفسه له، فقد سمع أن هناك
طبيبا هنديا ملحدا لكنه بارع فى الطب والصيدلة، فالتقى به وأخذ عنه علمه
وحاوره مثبتا له وجود الله، وقد كان فى عصره رجل ملحد اسمه أبوشاكر
الديصانى، ادعى أن الآية التى تقول «وهو الذى فى السماء إله وفى الأرض إله»
تدل على أن الله ليس واحدا وجاء رجل إلى الإمام الصادق ليعرض عليه هذا
الأمر فقال له: هذا كلام زنديق خبيث إذا رجعت إليه فقل له ما اسمك فى
الكوفة؟ فإنه سيقول لك فلان، فقل له ما اسمك بالبصرة؟ فسيقول لك فلان، فقل
له كذلك ربنا فى السماء إله وفى الأرض إله وفى البحار إله وفى القفار إله
وفى كل مكان إله، وبهذه الطريقة السمحة المسالمة فى النقاش والجدل، أسهم
الإمام فى تحجيم موجة الإلحاد تلك، وأهدى بكلماته السمحة العاقلة قوما
كثراً.
هكذا عاش الإمام سالما مسالما متحابا فى الله، ولا يألو جهدا فى التقريب
بين المسلمين والدفاع عن روحه السمحة وحث الناس على التمتع بالدنيا
والآخرة، مدركا أنه إن كانت للإسلام عظمة فإنها لن تكون إلا لأنه يستوعب
بعباءته السماوية كل المخالفين، يقف أمام
من يستخدم الدين لتمكين نفسه فى الحياة الدنيا، يحاجج الملحدين بالتى هى
أحسن دون أن يتعرض لحياتهم بشر، يسمع أن هناك قوما يضطهدون المسيحيين
فيسارع بالذهاب إليهم دفاعا عن أهل الكتاب مؤكدا أنه لا إكراه فى الدين،
وإن الاضطهاد سبيل من سبل الإكراه، يعطف على الفقراء والمساكين، ويسامح من
يسيئون إليهم، مرددا قول رسول الله «ما زاد عبد بالعفو إلا عزا» لكنه كان
شديدا على السلاطين غير هياب لهم، يحاول الملوك أن يهزوا صورته بأن يأتوا
له بأشهر الفقهاء فى عصره ليحاججه ويحرجه فينبهر هذا الفقيه به ويلزمه
مثلما حدث مع أبى حنيفة النعمان الذى حاول أن يرهق الإمام بأسئلته الشائكة
فأرهقه بإجاباته الشافية، فما كان من النعمان إلا أن يلزمه لزوم التلميذ
سنتين كاملتين، ليقول بعدها «لولا السنتان لهلك النعمان».
موقف أخير أعرضه قبل أن تنتهى تلك اللمحة عن بحر الإنسانية الرحب الإمام
جعفر الصادق، ولعل فى هذا الموقف ما يبرز لنا قوة الإمام وشجاعته وسرعة
بديهته فقد حدث ذات يوم أن استدعاه الخليفة المنصور بعد أن لفق له تهمة
أراد أن يشينه بها بعدما خشى من تجمع الناس حوله، وبعد أن فند الإمام
اتهاماته وأحرج خصمه الذى وافته المنية بعد تأكيد كذبه، حطت على وجه
الخليفة العباسى «المنصور» ذبابة وكان كلما أبعدها جاءته، فالتفت إلى
الإمام سائلاً: لماذا خلق الله الذباب؟ فأجابه بكل صدق وقوة وشجاعة وحكمة:
ليذل بها الجبابرة